

سيجد المتمعن فيما مضى من الكلام حول الدم المقدس وطبيعته أن المقاربات بين المقدس والمندس أو النجس تجعلنا نولي وجوهنا عمّا نادت بها شرائع السماء ونتجه نحو ما كتب في أسفار اليهود والنصارى، أي إلى العهد القديم والجديد، وفي هذا السياق يندرج البحث عن العلاقة بين صانع المقدس وهو الإنسان كسلطة فردانية فرضت نفسها على النصوص المقدسة، وبين المقدس الذي ضمّ بين مكنوناته حاجات المجتمع كإيجاد شخصية مقدسة ذات نسب مقدس، وعندما نكتشف هذه العلاقة فإن حرية الإنسان ستصبح في خطر بلا أدنى شك، ولكن كيف ؟ عندما نقول: إن الممارسة لطقسٍ ما هي فعل فردي يخص شخصاً واحداً فهذا يعني أنه اعتاد على أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه، ويقوي هذا الشعور إذا وجد من يسانده فيها كأن يقول الكاهن: هذا ما أراده المسيح ليريح الفرد من أعباء ما يحمله من أثقال، أو أن يقول عالم الدين: الكل يرجع الى مرجعه، ففي كلا الحالتين النتيجة مدمرة لهذا الفرد والمجتمع، ففي الأولى سيعلن حرباً على الأبرياء، وفي الثانية سيعرّض الأبرياء للخطر، فتعيش المجتمعات حالات نفسية وأخرى عصبية جراء وجود هذه الممارسات الطقسية تحت غطاء التقديس.
إذا أصبح العالم المقدس محفوفاً بالمخاطر يعيش فيه الإنسان حالة الارتباك ويكون مهدداً بالهلاك لدى أدنى انحراف ممكن، والذي سيفقده حريته فيسعى ليقي نفسه من رعب هذا المقدس، ولكن هل هذا يكفي ليقي الإنسان نفسه من هذا الرعب فعلاً وهو صانعه؟ إنها طرفة أليس كذلك أن يصنع الإنسان طقساً دينياً مقدساً ثم يأتي ويتحدث عن حريته وهو الذي وضع الموانع لحريته؟.هنا يطرح سؤال مهم ما هو السرّ وراء ذلك ؟ جوابنا لهذا السؤال سيفتح لنا أبواب الفصول موضوع البحث.
في مناخ التسعينيات من القرن العشرين احتدم جدال كبير على الساحة العالمية بين الفصائل الثقافية والسياسية لمن تكون المرجعية ؟ خاصة وأن هناك تيارات سياسية ليس لها مرجعية معينة حتى في أمور الدين حيث لا توجد هناك مرجعية موحدة ، فأصبحت المرجعية إحدى موضوعات الجدل، وفي المقابل تعالت الأصوات تطالب بالحرية المطلقة ليزيد الجدل حول الثوابت، أي المقدس فأصبح المقدس والحرية على طرفي النقيض.
والحوار بين المقدس والحرية يتميز بأن كليهما يملك آلة حربية ويستخدمها وكأنها لحظة يحاول كل فريق استبعاد الآخرين لصالح قوة أخرى، وهي القوة التي لا يمكن رؤيتها على شاشات التلفاز لأن الرمزية المقدسة هي التي تطلعهم على خفيات الأمور وهو ما نسميه عمليات من خلف الكواليس لنوضح أكثر، الدكتور خزعل الماجدي في إحدى لقاءاته قال: إنه لا يوجد أثر في الحضارة المصرية لموسى كليم الله الذي خرج على فرعون، بينما نجد هناك أدق التفاصيل عن ملوك مصر" تاركاً البحث فيما جاء في القرآن الكريم عن قصة موسى كليم الله وبرديات التي اكتشفت في السقارة في منطقة الجيزة في مصر ، (ملاحظة سنأتي على ادعاءات الدكتور خزل الماجدي وغيره في قادم الحلقات)
الآن ما يهمنا هنا أن العواقب المترتبة في ادعاءات كاذبة تنشر عبر وسائل إعلامية لها تأثيرها على الإدراك العام ، والأمثلة الدالة على هذه الادعاءات الاعتقاد أن الحق الإلهي هو إلى جانب هذا أو ذاك عند هذا الدين أو ذاك ، ومن عارضهم فهو كافر مدنس نجس .بهذا المنطق يبدأ المقدس بأخذ دور التماثل كآلية السيطرة، والسلطة تمكّن صاحب السلطة من اتخاذ آليات ثابتة في المجتمع، ويمارس المقدس فاعليته على الآخرين مثلما عزى البابا أُوربان أنّ ذلك هو إرادة الله بقوله: "إن اتّضح أنّ أُولئك الّذين ينضمّون إلى الجيوش المسيحية وفقدوا حياتهم في القتال سواء في البحر أو البرّ أو على يد الأوثان، فهم شهداء دمٍ، تُغفر لهم ذنوبهم، أؤكِّد ذلك بسلطة الله المعطاة لي". (1)
علماً أن الحروب الصليبية لم تكن بنت ساعتها، بل بدأت بإعلانات كاذبة أن الإسلام بدأ بتدمير آثار المسيحيين في الأرض المقدسة عام 1095م، ولأن الديانة المسيحية الوحيدة كانت قوية آنذاك أصبح لزاماً على كل واحد دخل المسيحية ودهن بالزيت المقدس أن يشارك في هذه الحروب، ورفع الأسقف ميلانو الحظر في تجنيد المسيحيين وإعطائهم السلاح لمحاربة الأوثان حسب زعمه، ويقصد به الشعوب غير المسيحية . فلنسترح قليلاً ثم نعود . والحمد لله رب العالمين.
المصادر
1.قصة الحروب الصليبية ، وولتر زولنر ، ص 50



 الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع وهي جريمة مكتملة الأركان في حق المجتمع كله
الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع وهي جريمة مكتملة الأركان في حق المجتمع كله
 رسالة حـ.ـزب الله إلى حضرة الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا لاوون الرابع عشر
رسالة حـ.ـزب الله إلى حضرة الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا لاوون الرابع عشر
 قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
 مفكر فرنسي : الغرب لا يري الإسلام مشكلة ثقافية بل تهديد وجودي
مفكر فرنسي : الغرب لا يري الإسلام مشكلة ثقافية بل تهديد وجودي
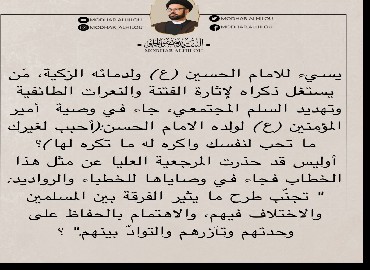 السيد مضر الحلو : لا للطائفية
السيد مضر الحلو : لا للطائفية
